24 أبريل .
17 دقيقة قراءة .
811
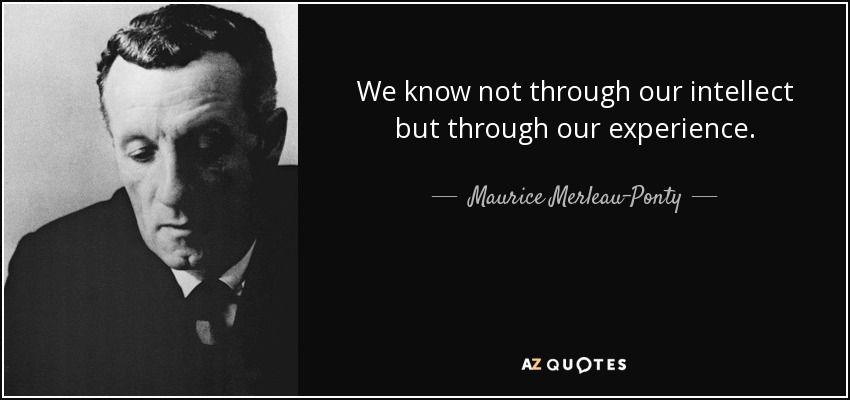
في كتابه (المرئي واللا-مرئي)، يواجه موريس ميرلو-بونتي معضلة مفادها أنه في محاولتنا الاقتراب من الشيء من خلال التفسير أو التنظير، فإننا في الواقع ننعزل عن خبرة "نعرفها" مسبقًا. "إن العالم هو ذلك الذي أدركه، إلا أن قربه المطلق يصبح بدوره، بشكل مستغلق، بعدًا معضلًا جديدًا حين نتفحصه ونعبر عنه". يشرح ميرلو-بونتي الإحباط من عدم قدرة اللغة على نقل التفاصيل الدقيقة للخبرة المجسدة، والصعوبة التي تصاحب محاولة نقل الانطباعات خارج التناقضات الثنائية والفئات الثابتة. يكتب: "ولكن بقدر تعايش القناعتين دون عسر في مسيرة الحياة، بقدر ما تقوض أحداهما الأُخرى وبقدر ما تشيعان بيننا البلبلة اذا ما اختزلتا في اطروحات أو ملفوظات". قد تنخرط الفلسفة في محاولة التعبير عن خبرتنا عن العالم، لكنها في الوقت نفسه "ليست معجما وهي لا تهتم"بدلالات الكلمات"ولا تبحث عن بديل لغوي للعالم الذي نراه، وهي لا تحوله إلى شيء مقول". هنا يفتح ميرلو-بونتي المجال لأسلوب أدبي أكثر حرفية ليأخذ التعبير عن العالم من الفلسفة. وبالمثل، فإن عالم الرسم غير اللفظي، المرتبط مع الأدب بـ "رابطة مشتركة" هي التعبير الإبداعي، قادر على إيصال ما تفتقده النظرية. على الرغم من مهارة ميرلو-بونتي ككاتب، يشعر المرء أنه غير مرتاح في الجانر الذي اختاره، وأنه ربما كان يفضل أن يلتقط فرشاة ويرسم ما يحاول قوله. لأنه كما يكتب في (العين والفكر)، "الرسام، مهما كان، وبينما هو يرسم، يمارس نظرية سحرية للرؤية".
الكتابة التي تنتج عن الاعتراف بهذا العجز لا بد وأن تكون غامضة ومبهمة، تتأرج بين التقدم والتراجع كما لو كانت تخشى تخويف الشيء الذي تحاول التقاطه. في الفصل الرئيسي من( المرئي واللامرئي) بعنوان (الإنشباك – التصالب)، يصل ميرلو-بونتي إلى قمة الشعرية في أُسلوبه و كأنه يسير على أطراف أصابعه وهو أقرب ما يكون إلى لب فلسفته: بالضبط عند تلك النقطة "الأكثر صعوبة" التي تتطابق فيها الأفكار مع تجسدها اللحمي في الكلمات. لا تزال الفجوات والغموض ومشاكل التعبير على المستوى الشكلي للنص تنعكس في الفلسفة نفسها. وربما من المفارقات أن ما يظهر هو فلسفة الامتلاء. إذ من خلال الإدراك، نختبر "كلية" معجزة تجبرنا على رفض الشك والقبول بالعلاقة بين الوعي والعالم مهما كانت غامضة، فـ"نحن نرى الأشياء نفسها، العالم هو ما نراه". يتميز النص في كل مستوى بالتفاعلات المعقدة بين الغياب والحضور - المرئي واللامرئي. يتجسد هذا الشعور بالمفارقة في مفهوم اللحم، الذي يستخدمه ميرلو-بونتي كنوع من "النموذج الأولي للوجود". تثير كلمة "اللحم" ردود فعل قوية ومتناقضة. إنه مثير ووحشي في آن واحد، يستحضر أفكارًا متزامنة عن الرغبة واللحم الميت، عن الصلابة والتحول. اللحم حقيقي بلا شك، ومادي؛ وأن يتجسد، "أن يُجعل لحماً"، يعني أن يُحضر إلى الوجود، أن يكون حتمًا "هنا". ولكن في نفس الوقت، فإن اللحم عرضة للتغيير. اللحم ينمو، يمكن أن يصاب، ويموت. إن لحم جسدي هو ما يحيط بي، ويشكل حدودي، بينما هوأيضًا أوضح نقطة مشتركة بيني وبين رفاقي من البشر. على الرغم من اعتراضات ميرلو-بونتي على أن ما يقصده من توظيف الكلمة "ليس مادة، وليس فكرا، وليس جوهرا"، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة أن الاسم الذي يختاره لإعطاء هذا الجانب الأكثر مركزية في فلسفته عن الأنطولوجيا يستحضر معه كل هذه المادية والكثافة والجسدية. في الواقع، إنكاره للحمية اللحم، وإصراره على صرف أنظارنا عن تلك الأشياء التي تجذبنا اليها الكلمة بقوة، يخلق نوعًا غريبًا من الازدواجية التي يجب أن تكون جزءا من فهمنا لها. يتشكل هذا الفهم في فصل "الإنشباك - التصالب". هنا، تصبح الروابط بين نظرية الإدراك والأنطولوجيا أكثر وضوحًا من خلال استكشاف العلاقة بين الذات المجسدة والعالم. يقدم الفصل ليس فقط مفهوم اللحم، ولكن أيضًا مفاهيم مثل الانعكاس الإدراكي(المعكوسية)، والعلاقة التصالبية بين الجسد والعالم وتفاعل الجوانب المرئية وغير المرئية للخبرة.
في الفصل، تحضر الخبرة الجمالية كموقع لبروز مكثف للكينونة، ويطور ميرلو-بونتي حججه التي قدمها عن الرسم في (العين والفكر) فيما يتعلق بالموسيقى والأدب. وربما أن المثير بشكل خاص هو اقتراح نوع من الإبداع الانطولوجي. هناك نظرية للكينونة تنظر إلى الكائنات الفنية وكذلك إلى خبرة العالم من أجل الأهمية الانطولوجية وتعترف في كل عملية بالبناء النشط نفسه، بالصيرورة. يبدأ الفصل بفحص الطريقة التي يرتبط بها الجسد المُدْرِك بالعالم المُدْرَك، والذي يعيد ويوسع في الوقت نفسه ما بدأه ميرلو-بونتي في( فينومينولوجيا الإدراك). بين رؤيتي والعالم المرئي، يخبرنا ميرلو-بونتي بأسلوب مجازي، أن هناك "علاقة حميمة كالتي بين البحر والشاطئ". ومع ذلك، فإن هذه العلاقة الحميمة لا تميل إلى "انصهارنا فيه أو لانتقاله هو إلينا. إذا حينئذ ستتلاشى الرؤية لحظة حدوثها إما باختفاء الرائي او باختفاء المرئي". يصف ميرلو-بونتي ما يحدث على أنه نوع من العناية، أو "جس" للأشياء بالبصر الذي "يكسوها بلحمه" ويحفظ لها "وجودها السيادي". هذه العملية المتناقضة ظاهريًا ممكنة فقط إذا توقفنا عن التفكير في الشيء المرئي بوصفه "جزءا من كيان مطلق الصلابة، ومتعذر القسمة، ومتاحًا بكامل عرائه لرؤية لا يسعها إلا أن تكون تامة أو معدومة" واعتباره بالأحرى "ضربا من مضيق بين آفاق خارجية وآفاق داخلية منفرجة دوما وأنه شيء ما يأتي ليلامس بلطف وليجعل عن بعد جهات متعددة من العالم الملون أو المرئي تتصادى، أنه تخلق معين وقولبة عابرة لهذا العالم، واذًا ليس هو لون أو شيء بقدر ما أنه فرق بين أشياء وألون، إنه تبلًر مؤقت للكائن الملون أو للمرئية، فبين الألوان والمرئيات المفترضة سنلتقي من جديد بالنسيج الذي يبطنها ويسندها ويغذيها والذي هو ليس شيئا وانما امكان وكمون ولحم للأشياء". "شكله الدقيق" إذا محاصر في شبكة من العلاقات المتبادلة مع الأشياء المرئية الأخرى، كلاهما موجود على الفور وبعيد زمنيا ومكانيا. من خلال التفكير بالإدراك بهذه الطريقة، يأمل ميرلو-بونتي في إعادة اكتشاف ليس المحتويات الخفية للوعي القائم بذاته، ولكن النسيج الضام الذي يبطن[الأشياء المرئية] ويسندها ويغذيها والذي هو ليس شيئا وانما امكان وكمون ولحم للأشياء"." بينما لا يُقصد به أي نوع من الجوهر بالمعنى الديكارتي، فإن مصطلح "اللحم "، كما يعترف ميرلو- بونتي، ليس مطابقة، و"لا تشبيه أو مقارنة غامضة". إنه يشير إلى "العلاقة الحميمة للتناغم المحدد مسبقًا" التي للجسد الرائي مع الأشياء المرئية؛ هذا هو السبب في أنني لا أرى الأشياء عن بُعد فحسب، بل إن نظري "يحيط بالأشياء المرئية ويجسها ويقترن بها.... وكأنما كان يعرفها قبل أن يعرفها".
طور ميرلو-بونتي فكرة أن الإدراك ينطوي على مشاركة نشطة من الأشياء المدركة من خلال فكرة الانعكاس الإدراكي. تم تقديم هذا الانعكاس لأول مرة ليس من خلال مفهوم الرؤية، ولكن من خلال اللمس.بعبارة أخرى، "إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت يدي المحسوسة من الداخل يمكن الوصول اليها كذلك في نفس الآن من الخارج، فهي ملموسة هي ذاتها بالنسبة ليدي الأُخرى على سبيل المثال، واذا أخذت مكانها بين الاشياء التي ألمسها تكون بمعنى منا واحدة منها، وتفتح في النهاية لى كيان ملموس هي كذلك جزء منه". كما هو الحال مع تجربة اللمس، كذلك الأمر بالنسبة لمجالات الإدراك الأخرى؛ بالإضافة إلى تداخل أدوار الذات والكائن، هناك تداخل (بدون تطابق) بين عوالم الملموس والمرئي. "يجب علينا"، كما يقول ميرلو-بونتي،" أن نعود أنفسنا على التفكير بأن كل ما هو مرئي محفور في الملموس، وكل كائن ملموس موعود بطريقة ما بقابلية الرؤية". يكتب في مكان آخر، "هذا التداخل غير العادي، الذي لا نفكر فيه أبدًا بشكل كافٍ، يمنعنا من تصور الرؤية كعملية فكرية من شأنها أن تضع أمام العقل صورة أو تمثيلًا للعالم، عالمًا من الجوهر والمثالية ". بدلاً من ذلك، يصبح النظر عملية حساسة. نظري ليس شيئًا يبقى داخل جسدي كتمرين لعقلي، بل إنه يتصل بالأشياء التي يراها. مثلما أمد يدي نحو ما ألمسه، وأوجد اتصالًا بين الجزء الخارجي من جسدي وسطح الشيء، كذلك تمتد رؤيتي للخارج، مما يخلق مسارًا للتفاعل بين آفاق جسدي وذلك الشيء المرئي. ما يظهر هنا هو عكس فكرة أن المكفوفين "يرون" الأشياء من خلال استخدام أيديهم. هذا هو شكل من أشكال اللمس من خلال العيون، "جس بالنظر". إذا أخذنا ذلك في الاعتبار ضمن هيكل الانعكاس، فسيترتب على ذلك أن الأشياء التي أنظر إليها أيضًا "تجسني"، تلمسني؛ إن النظر إلى العالم يعني أيضًا الشعور به، وأن تُرى يعنى أن تُلمس أيضًا. فبدلاً من الرؤية المنبثقة من الذات أو من العالم، تحدث الرؤية عندما يكون هناك تفاعل، "تبادل"، عندما يعود جزء من المرئي (على سبيل المثال، أنا) إلى بقية ما هو مرئي (مثل العالم). لذلك تتشكل الرؤية على أنها "رؤية [...] في حد ذاتها، والتي لا تنتمي إلى حقيقة الجسد ولا إلى حقيقة العالم - كما لو كانت على مرآتين تواجهان بعضهما البعض". لا تنتمي الصور المنعكسة إلى أي من السطوح على وجه الخصوص، بل "تشكل زوجا، زوجا أكثر واقعية من أي منهما". لذا فإن الرائي، وهو منخرط في ذلك الذي يراه، ما يزال هو ذاته الذي يرى ذاته؛ أنا نفسي مرئي ضمن المرئي الذي أوجه رؤيتي إليه. ومن ثم، "هنالك نرجسية أساسية لكل رؤية". لكن هذا لا يأتي فقط من حقيقة أنني أرى نفسي في المرئي، بل كما لو أن الأشياء المرئية توجه نظراتها إليّ، كما لو أنني اختبر نفسي ليس فقط كمن يُرى من الخارج، ولكن في الواقع "مرئي من قبل الخارج". بهذا المعنى، "الرائي والمرئي يتبادلان بعضهما البعض ولم نعد نعرف من يَرى ومن يُرى"؛ هناك "رؤية" مجهولة وعامة. هذه العمومية التي تقع "في منتصف الطريق بين الفرد المكاني والزماني والفكرة، نوع من مبدأ مجسد يجلب معه اسلوب كيان في كل مكان يوجد فيه جزء صغير منه" هي ما يُطلق عليها اسم اللحم، الذي هو بهذا المعنى :اسطقس" كينونة. يربط عصبها بين الإنسان واللاإنساني، وتصبح الأشياء، "الخارج"، متحركة، وتعمل كبصاصين دائمين على كياننا.
وتمامًا كما انهار الحد الفاصل بين وعيي بالأشياء التي أراها والأشياء نفسها، كذلك بين الخط الفاصل بين الاستعارة والحقيقة. يطرح ميرلو-بونتي احتمال أن يكون لرؤيتي تأثير على العالم الخارجي الذي أنظر اليه الذي ينظر اليً. تصبح خبرتي مع العالم " ذلك الاختلاط بالعالم الذي يتجدد عندي كل صباح مذ افتح عيني، وإلى تيار الحياة الادراكية هذا الذي بيني وبين العالم والذي لا يكف عن الخفقان صباح مساء، والذي يجعل أفكاري الأكثر سرية تغير عندي ملمح الوجوه والمناظر كما بالمقابل تساعدني الوجوه والمناظر تارة وتهددني طورا بما تبثه في حياتي عن الكيفية التي أكون بها إنسانا".
ومثلما رأينا في (فينومينولوجيا الادراك)، يترك ميرلو-بونتي الأمر غير واضح على مستوى ما ما إذا كان تحول الظواهر المادية يحدث بالفعل أم أنه ظاهر فقط، هنا فقط يتضاعف التأثير، وتصب الأشياء الخارجية تحولها الخاص في عين المراقب. من الطبيعي أن يكون لهذه الكيونة-في- العالم آثار على مستوى الذات. تتأرجح الكينونة بين مضاعفة الذات وخسارة الذات. يتم تدمير فكرة الوعي الأنانوي لصالح الذات التي تعتمد على الخارج، مما يؤدي إلى انهيار الفروق الديكارتية الصارمة بين الذاتية والعالم المادي. يبدو أن نوع الإنسانية الذي توصلنا إليه علاقة الانعكاس في نهاية المطاف هو نوع " أنا ' يتضاءل في وجه شيء يتجاوزني، في مواجهة لحم يغلف كل شيء. يصبح العالم المادي الذي يمكن إدراكه والذي أشارك فيه في مثل هذه العلاقة الحميمة "حماية" و "تهديدًا". إنه يجلب لي امتلاءً وواقعية ومعنى لا مثيل له، ويعزز نفسي مرتين، لكن هذا بالضرورة يجلب معه قلقًا متزايدًا. لقد امتد احتمال الأذى الشخصي إلى ما هو أبعد من حدود الذات لتشمل محيطها المادي. "أنا" مدعوم ومختزل ومضاعف ومنفسم.
ومع ذلك، فإن لحظة التبادل العكسي، النقطة الدقيقة للتحول بين المدرك والمُدرك "هي دائمًا متأصلة ولم تتحقق أبدًا في الواقع". النقطة التي عندها حالتي كذات مدرِك وككائن مدرَك لا تُتاح لي أبدًا: لا يمكنني لمس نفسي وهي تلمس. لا يمكنني أبدا أن اتطابق تماما مع نفسي. على الرغم من وجود تبادل انعكاسي للموضوع والكائن، يجب أن يظل موضوع الإدراك منفصلاً ومتميزًا عن الكائن المدرك من أجل إدراكه.
"يدي اليسرى دائمًا على وشك أن تلامس اليمنى وقد لمست الأشياء، لكنني لم أصل أبدًا إلى التطابق؛ إن التطابق يتسرب في لحظة التحقق [...] انا اختبر - وبقدر ما أرغب في كثير من الأحيان - الانتقال والتحول من خبرة إلى أخرى، ويبدو الأمر كما لو أن المفصل بينهما، صلب، لا يتزعزع، ظل مخفيا عني بشكل لا يمكن إصلاحه".
هناك، إذن، فجوة، ثغرة، غياب في صميم خبرتي، ووجودي؛ في الواقع، حضوري لنفسي مؤجل باستمرار. ومع ذلك، فإن هذا التأجيل المستمر للوجود يختلف عن نوع التأجيل الذي وصفه دريدا. بالنسبة له، فإن اللعب بين الدوال لا يصل أبدًا إلى أي حد نهائي، ويتبدد مفهوم الحضور. لكن بالنسبة لميرلو-بونتي، كشف لنا "الإيمان الإدراكي" أن العالم موجود بالفعل، وأننا ندركه حقًا. هناك شيء ما وراء الإدراك (وما وراء اللغة) يشير إليه، تجربة بدائية قبل التأمل. لذا فإن الفجوة في قلب الخبرة ليست لا شيء حقًا، "ليست فراغًا وجوديًا، أو لا وجود: إنها امتداد من خلال الكيان الكلي لجسدي وجسد العالم؛ إنه صفر الضغط بين اثنين من المواد الصلبة التي تجعلها تلتصق ببعضها البعض".
وبالتالي، فإن الفجوة أو الاختلاف بين مصطلحين لا تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الديفيرانس الدريدي، الذي يفصل أو يفكك، والذي يأخذنا إلى الأبد إلى ما وراء عالم الامتلاء أو الوجود. من المفارقات أن الفجوة أو الاختلاف بالنسبة إلى ميرلو-بونتي هي نوع من القوة الموحدة. الفراغات الموجودة في الما-بين ليست فراغات خارجية للإبادة، لكنها جزء من نسيج الجسد. إن الحضور ليس مفككًا ولكنه ينبني على عدم التطابق، على الاختلاف: "الحضور الذاتي هو حضور لعالم متمايز". أنا والأشياء جوانب مختلفة من بدن واحد. نسيج المرئي مستمر وأي شيء يظهر بداخله منسوج بشكل لا ينفصم مع الأشياء من حوله، بالإضافة إلى الأشياء المرئية الأخرى غير الموجودة، الأشياء التي بالنسبة لي، يرتبط لها الشيئ. أنا جزء من نسيج رؤية هذا الشيء أيضًا، وبالتالي فأنا أحد الأشياء التي يرتبط بها. الفراغ بين الأشياء، مثل الفجوة في مركزي، مملوء باتساع جسدي والعالم، بسمك اللحم.
إن الفجوة في كينونتي ليست غيابا بالضبط. ليست فقدا بشكل نهائي، لكنها متاحة من خلال تقريبها، تمثيلاتها لنفسها. إن "النقص" ذاته للعنصر المفقود يبني خبرتنا معه حتى عندما لا ينتقص من سيادته أو من إيماني بحقيقة وجوده. قد يكون جسدي هو الوسيلة الوحيدة التي أمتلكها للمجيء إلى العالم، لكن التأثير المتقلب والمحدود لوساطته لا يعني أن الشيء نفسه يتقلب أو يكون محدودًا: "إن حراك المظهر لا يكسر يقين الشيء ". مثلما لا يمكننا لمس شيء ما دون تغطيته بجزء من أجسادنا - يدنا على سبيل المثال - كذلك من المستحيل رؤية شيء ما دون تغليفه بأنظارنا. هذا "التستر" أو النقطة العمياء لا يمنعني من تجربة الأشياء نفسها، "فالأمر لا يتعلق بطبقة أخرى أو بحجاب قد يأتي ليقوم بين الأشياء وبيني ". في الواقع، هذه النقطة العمياء هي التي توفر وسيلتي الوحيدة للإقتراب.
*الاقتباسات في النص من ترجمة الدكتور عبد العزيز العيادي لكتاب"المرئي واللامريئ"
01 مايو . 18 دقيقة قراءة

