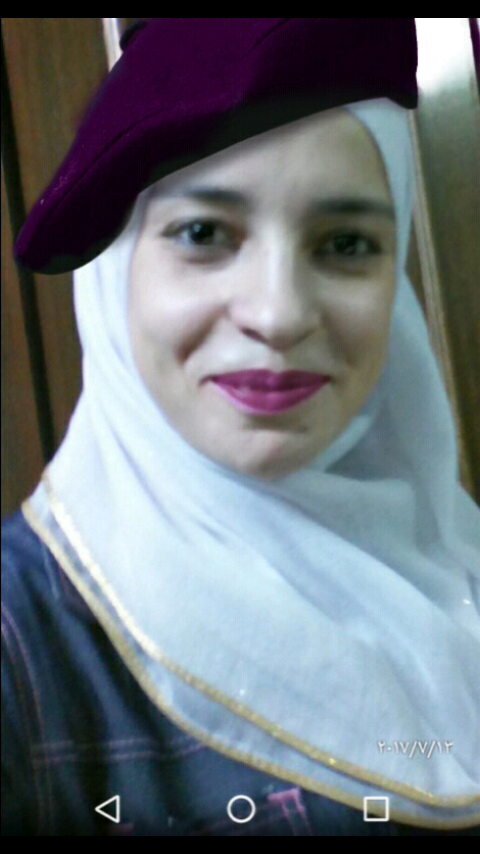17 يوليو .
8 دقائق قراءة .
1362

في قريةِ تبنينَ الجنوبيّة، حيثُ الكون قد جدلَ سكونه خيوطًا وحاكَ هدوءه غطاءً وأسدله على تلك القرية لتنامَ هانئةً وادعةً بين أحضان جبل عامل. لا يقطع أوصال هذا السّكون سوى ثغاء ماعزةٍ شاردةٍ عن قطيعها أو "ميجانا" فلّاحٍ قد أسكره العرق المتصبّب على جبينه. في هذه القرية، وُلِدَت زينب كأيّةِ فتاةٍ أخرى. وأُشدِّدُ على عبارة "كأيّةِ فتاةٍ أخرى". فالفتيات يولدنَ عظيمات مع مهمةٍ عظيمة، يُنمّيها المجتمع أو يقتلها في مهدها.
هي زينب فوّاز المولودة بين عامَيْ ١٨٤٥ و١٨٥٠. شهادةُ ميلادها ضائعة وما أبقت للتّاريخ سوى شذرات ذكرياتٍ في ذاكرةِ مُعَمِّري القرية. لكأنّها عدوّةُ التّاريخ اللّدودة. كلّما طبعت أثرًا لها، مسحها بممحاته الّتي لا ترحم. هذا السلطان الجائر، لم ينصفها سوى في توقيت مولدها المتقارب من ابنة علي بك الأسعد وفاطمة الخليل وهما من أعيان القرية. أرادا رفيقةً لطفلتهما فكانت زينب فوّاز. قادها قدرها إلى قلعة بيت الأسعد وللتصويب فإنّ زينب فواز قد قادت قدرها إلى منابع العلم والمعرفة المتفجّرة داخل القلعة. فالعلوم تختار من ينهلها وتناديهِ إليها. "ندّاهةٌ" هي، تعبِّدُ الطريق وتضيئه وتسوق مُختارَها إليها. وقد أخذت هذه الندّاهة زينب فوّاز ورمتها بين ثنايا علوم الصرف والنحو والنقد.
وقبل أن نبدأ حكايتنا فلنتعرّف إلّيها بل فلْتُعرِّفنا هي عن نفسها كما فعلت في مقدّمة كتابها "الدرّ المنثور في طبقات ربّاتِ الخدور": أنا المفتقرة إلى الله وبه أستعين، زينب بنت علي فوّاز بن حسين بن عبدالله بن حسن بن محمد بن يوسف بن ابراهيم فواز، السوريّة مولدًا وموطنًا، والمصريّة منشأً وسكنًا.
وإذا تُرِكَ لي التّعريف عنها أقول: هي زينب فوّاز المجبولة من إيقاعٍ موسيقيٍّ شرقيٍّ يظهر جليًّا في سجعها الَّذِي اتخذته شعارًا لها خاصّةً في اختيار عناوين كتبها. هي زينب المُحجّبة مظهرًا، المرفوع عنها الحجاب عقلًا وتفكيرًا. هي زينب "غير الجميلة وغير الأنيقة" شكلًا-كما وصفها جرجي باز في مجلته "الحسناء"- والسّاحرة وعيًا وعلمًا. هي زينب الّتي ظلمها مُثقّفو عصرها بعدم ذكرها وأقساه قد وقع عليها من معاصراتها من النِّسَاء.
في روايتها "الملك كورش"، تظهر زينب الحكّاءة وهو ما تشرّبته من قرويّتها. كلُّ قرويّ حكّاءٌ، يرضع فنّ سرد القصص من أثداء الأمّهات والجَدّات، فتأتي حكايته لذيذة مقرمشة، تنزل على البطون المتضورة جوعًا إلى حبكتها فتملؤها. لكنّ زينب لم تكتفِ بسدِّ الأفواه الجائعة بل هدفت إلى ملءِ العقول وإنارتها. لغتها، في هذه الرّواية بسيطة، والبساطة فنٌّ في سرد الحكايات. انسيابيتها متدفّقة، لا تعترض طريقها استرجاعات ولا استباقات. شخصيّاتها غزيرة ومعقّدة حتّى أنّنا لنتساءل ونجيبُ في آنٍ معًا: من أين لهذه العامليّة هذه المخيّلة الخصبة، من أين لها هذا التعمّق في النفس الإنسانيّة؟ ونُجيب: هي العامليّة الّتي نشأت في جبل عامل حيث لا حدود سوى السّماء. حتّى أنّ سلسلة جبال لبنان الغربية الشّامخة تنخفض جنوبًا وتركع عند سفوح جبل عامل لتتلاشى نهائيًّا. بيئةٌ تطلقُ البراح للبصر والبصيرة في آن.سؤالٌ آخر يُطرح في هذه الرّواية: من أين أتت زينب في عام ١٩٠٤-١٩٠٥ بفكرة أن يتربّع ابن راعٍ على عرش أعظم مملكة؟ كيف لمن تربّى على أيدي راعٍ أن ينشأ بمثل هذا الذّكاء وهذه القدرات؟ والإجابة بسيطة وصارخة. زينب فوّاز كانت تتحدّث عن نفسها. طفلةٌ تربّت في كنفِ عائلةٍ بسيطة، والدها راعي ماشية ووالدتها فلّاحة لكنّها تربّعت على عرش الأدب وتُوِّجَت علمًا من أعلام عصرها. نعم، الملك كورش هو زينب نفسها.
مُخطِئٌ مَن يعتقد أنّ زينب لم تذكر شيئًا عن نفسها خاصّةً في كتابتها عن رائدات عصرها في كتابها "الدرّ المنثور" بل إنّها كتبت عن نفسها في كلّ رائدةٍ تحدّثت عنها. كتاباتها عن تلك النِّسَاء إن هي إِلّا مرآة تعكس دواخل شخصيّتها. مَنْ يتلمّس مبكرًا ذكاء زينب فوّاز ، يعرف حقّ المعرفة أنّها كانت تجاهر لا بل تصرخ وهي تخطّ معالم شخصيّتها في كل كلمة تكتبها. لم تنتظر أن يأتي من ينصفها كمَيْ زيادة بل أنصفت نفسها. وَمَنْ يعي حقيقة حجابها ويحترمه، يعلم أنّ هذا الحجاب إنَّما هو تعبير عن عِزّة نفسها في التحدّث عن شخصيّتها بشكلٍ مباشر.
ذكاء زينب أنّها قد تركت الباب مفتوحًا أمام من يريد التّعرّف إليها. عليه فقط أن يخلع الحجاب الّذي يغطي عقله وأن يتلذّذ باكتشاف امرأةٍ استثنائية، تحدّت كل الظروف الّتي كانت تسمح للنّساء بالبروز في عصرها. تحدّت القرويّة. تحدّت جمال الشّكل والأناقة. تحدّت الخنوع الزّوجيّ. تحدّت كلّ هذا وبزغت فجرًا جنوبيًّا، ملأ الشّرقَ نورًا وضياءً.