01 يناير .
11 دقيقة قراءة .
906
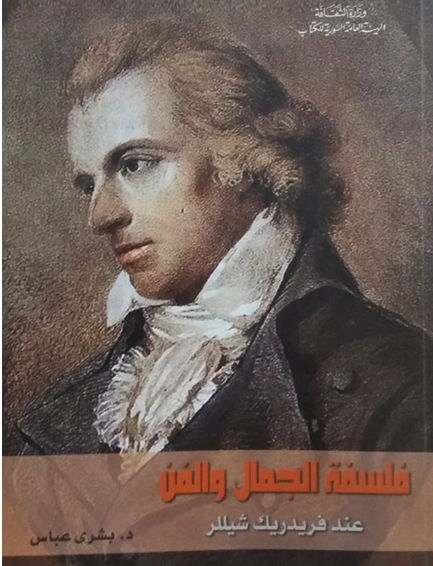
فريديريك شيللر: أنا جنتي.. وأنا جحيمي
أي دراسة عن الفيلسوف الألماني «فريديريك شيللر» (1759-1805) لا بُدَّ ستتطرق إلى شخصيته التوفيقية، وقدرته على إيجاد جسور ونقاط اتصال بين الأضداد، فمنذ رغبته بدراسة اللاهوت ثم انتقاله إلى الكلية العسكرية بفرض من دوق مدينته، مروراً بخياره دراسة القانون ضمن تلك الكلية وتحوِّله بعدها نحو الطِّبّ، كل ذلك جعل مشروعه العام يركز على الإنسان وحريته التي يُعبَّر عنها عن طريق الأخلاق، ثم العمل على إظهار فن ينجم عن تربية جمالية تتيح للمواطنين مقاربة السياسة بصورة مختلفة «كي لا تتكرر مجزرة الثورة الفرنسية» بحسب تعبيره، وصولاً إلى المُصالحة بين شرائع الطبيعة ومقتضيات العقل العملي عبر الجمال، الذي يوحد بين الحس والعقل، ويُضفي على الروح قدراً من الواقعية، تحرر الإنسان من شتى ألوان العبودية، كما تُخضِع طبيعتنا الشهوانية -من دون إلغائها- لتطهير أولي، فالجمال، بحسب شيللر، يقودنا إلى عتبة الحرية الأخلاقية، بعد ذلك يدعونا إلى تجاوز هذه العتبة، لكي نكون مستعدين لحرية روحية تبدو في بعض المواقف أنها جليلة وبطولية في وجه الحتميات التي ترهقنا.
إعادة النَّظر في ذاتية الإنسان وعلاقته مع الله، وتفنيد رؤية «شيللر» عن الدين، وفلسفته الخاصة بالفن والجمال، ونظرته للتاريخ والسياسة والثقافة والمجتمع والدراما والشعر، هو ما فنَّدته الدكتورة «بشرى عباس» في كتابها «فلسفة الجمال والفن عند فريديريك شيللر» (الهيئة العامة السورية للكتاب)، إذ بيَّنت أن الاتحاد بين الآلهة والناس تعد الصيغة الأعلى لفكرة وحدة الشمل التي تُشكِّل مع فكرة الحرية أحد أقطاب التأمل النظري في كتابات هذا الفيلسوف، فعن طريق تقدير الإنسان لذاته، يتحرر من آلهته القامعة ويحولها إلى فكرة ألطف لا تنفصل عن وجوده، هكذا تتحول القوة المخيفة التي أنتجها الشرق إلى صورة تتناغم مع الإنسان في المخيلة الإغريقية، حيث كان الخير الأعظم يتجلى في المتعة والصحة والسعادة، خلافاً لما نراه في الدين المسيحي الذي شتت شمل الإنسان، إذ فرَّق بين الروح والجسد، وأذلّ الجسد أمام الروح، مُعلناً أن إشباع أكثر الوظائف طبيعية يعدّ خطيئة، لأن السعادة الحقيقية لا يمكن أن تكتمل إلا بعد فناء الجسد، وهو ما جعل «شيللر» يعتقد أن الإغريق جسدوا في لحظة تاريخية معينة وحدة شمل إنسانية، «ينبغي أن يكون بمقدورنا أن نعيدها إلى طبيعتنا التي دمرها خداع الحضارة وأن نرممها بالفن الرفيع، فالثقافة لا تُقوِّم من اعوجاج الطبيعة، بل تعيد إليها سموها الأصلي».
الفيلسوف الألماني شخّص مرض حضارتنا بوصفه صراعاً بين الغريزة الصورية/ الروحية والغريزة الحسية، على أن تكون مهمة الثقافة ضبط علاقة الغريزتين، إضافة إلى السعي لإذابة النزعتين الإنسانية الجمالية والإنسانية السياسية في إشكالية واحدة، عن طريق النظر للميدان السياسي بوصفه ظاهرة ثقافية أكثر مما هو قضية تنظير، إذ يتعين على الفن ألا يقدم حلاً نظرياً أو ذاتياً فقط، بل أن يكون له صلاحية إنتربولوجية واجتماعية، ولا يتحقق ذلك إلا عندما يتحول الإنسان من كونه كائناً طبيعياً في مجتمع بدائي يسميه شيللر «دولة الضرورة»، إلى شخصية جمالية تساهم في الانتقال إلى «دولة العقل»، لاسيما في ظل تشيُّؤ الإنسان واغترابه، واستلاب روحه وحريته في ظل الآلة الصناعية المنتجة، لذلك يستبدل رائد «التربية الجمالية» الثورة بالتطور في نظريته السياسية، لأن هذه المهمة الهامة هي نتاج عقل ولا يمكن تركها عرضة للعنف ولدوافع حشود الناس الغريزية.
لكن هل الجمال قادر على إصلاح الأخلاق، وتالياً معالجة فساد العصر، ومشكلة الدولة وفق رؤية شيللر؟ تجيب الباحثة «عباس»: الجمال وحده هو القادر على أن يضطلع بأصعب مهمة في الفلسفة الكانطية الكامنة في التصريح عن التآخي بين حدي التناقض، وهو الوضع المثالي الذي تتألف فيه الحكمة مع الحرية، فالدولة بعُرف شيللر ليست محض سيادة للقانون، إذ يتعين عليها أن تكون شكلاً موضوعياً يُمكِّن الإنسان من بلوغ الكمال بصورة تامة، وأن تكون في الوقت ذاته الغاية التي تصبو إليها الروابط الإنسانية، تلك الروابط التي أصابها الخلل بحكم الحضارة ذاتها، وظهور تخصصات كثيرة نسفت تجانس البشر، بحيث بات الإنسان جزءاً من كُلّ، تُهمَل كينونته الفردية عند توظيف الجماعة لخبرته، ليأتي الجمال فيحقق التناغم، واحترام الكل للكل، والأمان والحرية السياسية والمدنية، فلا يعود التعامل مع المواطنين إلا باعتبارهم شخصيات تعرف كيف تُسَخِّر نفسها لخدمة المثل العليا للعقل، وصولاً إلى الدولة الجمالية التي تعيد تكوين كينونتنا بحيث نُصبح جميعنا بشراً بصفاتٍ أسمى.
هنا يأتي دور الفن الذي يهيئ للأخلاق، فالفنانون هم الذين أوحوا للإنسانية بالأفكار الدينية الكبرى، الميتافيزيقية والحضارية والأخلاقية التي عايشتها، من دون أن يعني ذلك أن ينحو الفن باتجاه التنشئة التربوية، لأن «تحويله إلى مرشد هو جهل بغاياته وإزاحته عن طريقه»، كما أن تأثيره في الناس يكون غير مباشر، ولا يمارس هذا التأثير إلا بشرط ألا يحاول ممارسة هذا التأثير. «إن غاية الفن الحقيقية هي الغاية التي تسعى إليها الطبيعة، أي المتعة، وليس المقصود بالمتعة هنا التسلية العابرة، بل إثارة القوى الثاوية في نفوسنا بصورة كاملة. ولا ينبغي أن نعتقد بأننا نحط من شأن الفن بمنحه الغاية نفسها التي حباها الخالق لنفسه، ألا وهي إشاعة الفرح في كل مكان»، هذا ما أوضحه شيللر، مبيناً أن الأصل النفسي للفن هو الجميل الداخلي الذي يتقصى الحرية، ومصدره غريزي فطري ناجم عن الطبيعة، وهذه الغريزة هي «اللعب»، هذا المصطلح الذي كان بالنسبة لفيلسوفنا هو التعبير عن الإنسانية الحقيقية، لأن المرء لا يلعب إلا عندما يكون إنساناً بكل ما في الكلمة من معنى، كما أنه لا يكون إنساناً تماماً إلا عندما يلعب، فـ«اللعب هو الشكل العملي للحرية»، إذ يتخلص به الإنسان من دوائر الحتمية كلها.
فكرة الحرية عند فريديريك تحوَّلت من كونها مشكلة أخلاقية إلى مسألة وجودية، تكشف عن التضاد بين النسبي والمطلق، بين الزمن والكينونة، بين المتناهي واللامتناهي، وبالتالي تحدد المنظور الجديد حول الصيرورة الإنسانية، لاسيما عبر التأكيد أن القوة الصورية/ الروحية تمثل النواة الصلبة للمُطلَق الموجود في كل إنسان، والذي لا تقوم عليه الاستقلالية الأخلاقية فقط، بل المعرفة أيضاً، وبناء عليه تصبح «الذاتية هي مصدر الحقيقة»، إذ إن المتأمل يتخلى عن إنسانيته الخالصة ليحصل على إشباع لا يعادله إلا الغبطة الإلهية، من هنا يأتي تأكيد شيللر على المخيلة باعتبارها المبدأ الفعال الذي يفضي إلى الجلال، والإغريق بالنسبة إليه خير مثال على ذلك، إذ كان «اللاهوت عندهم ثمرة مخيلة موفقة، وليس ثمرة دراية عقلية كما هو حال العقائد الدينية في الأمم الحديثة»، تلك المخيلة ذاتها القادرة على جعل الشعراء يصلون إلى أقصى درجات السمو والنبل الإنساني من خلال العودة إلى طفولتنا كونها التجلي الكامل والوحيد للطبيعة الذي نجده في الإنسانية المتحضرة، مما يعيد لنا حالة التناغم مع أنفسنا، عبر نوع من الهروب من تلك الإنسانية باتجاه الطبيعة، التي كنا نشعر ونحن أطفال لها بالسعادة والكمال، ثم فقدناهما مذ أصبحنا عبيداً لمقتضيات الحاضر وآلاته البغيضة.
لكن هذا الألم الذي أصابنا نتيجة الحضارة والبعد عن الطبيعة قد يودي بنا إلى الجلال إن عرفنا استثماره، وانطلاقاً من ذلك اعتبره شيللر القانون الأول للفن التراجيدي، بينما يكمن القانون الثاني في تجسيد المقاومة الأخلاقية لذاك الألم، مما يحقق المتعة التراجيدية التي تنجم من الصراع بين إرادة الخير وإرادة الشر، أو بين الوضوح الأخلاقي والضلال العاطفي، ولذلك ينتظر من البطل التراجيدي أن يعطينا فكرة قريبة من الجمال المثالي الذي يأتلف فيه الواجب مع الغريزية بصورة كاملة، وهذا يفترض أن يكون البطل حراً أو أن تنتصر الحرية في داخله في النهاية، لكن من ناحية أخرى يجب ألا يتحمل البطل مسؤولية مصائبه، فالإحساس الواضح للبطل بعقدة الذنب تضر بشفقتنا، كما أنها تمنح التراجيديا مظهراً مُخالفاً لشروط الجميل. ولا بأس أن يؤدي القدر في الدراما دوراً ما، لكن يتعين على هذا القدر الخارجي من حيث الظاهر أن يكون داخلياً، ويتلبّس لباس القانون الأخلاقي، طبعاً مع ضرورة الحد من تعديات التاريخ التي تهدد بإخماد جذوة الدراما.
يقول فريديريك: «تبدأ سلطة المسرح حيث ينتهي ميدان القوانين الإنسانية، فالمسرح يقدم عوناً كبيراً للقوانين والأديان عندما تتحالف معه.. وهو مدرسة للحكمة الشعبية، إن المسرح قناة مشتركة يمر عبرها نور الحكمة انطلاقاً من صفوة المجتمع المثقفة، وينشر إشعاعه في كافة أرجاء الدولة.. وهكذا تسري في شرايين الشعب الأقوال المأثورة الأكثر نقاءً وعدلاً والمشاعر الأكثر صفاء، فيتبدد ضباب البربرية والشعوذة المظلمة».
وفق هذه الرؤية أبرز شيللر التعارض بين الحضارة والطبيعة في مسرحيته "اللصوص"، بينما لم تكن «دسيسة وحب» سوى مرافعة ضد الطبقات المتحيزة التي تهضم حقوق الحب، وضد اللا إنسانية في المجتمعات الحديثة، بينما مجّد في مسرحياته اللاحقة الجهود الأخلاقية لمواجهة الأقدار المضادة، وذلك بلغة تهكمية عالية ناجمة عن وعي حاد بمصطلح «اللعب» ضمن المسافة بين الموضوع والذات، وبين الذات ودورها في الارتقاء والسمو. ما جعل الكثيرين من دارسيه يُحدِّدون ذاك التهكم كأحد أبرز ملامح رومانسية شيللر المعتدلة التي تناصر مبدأ الحرية في الأدب، لكنها تُصالح بتناغم بين الحرية والنظام، مثلها مثل الكلاسيكية التي تقاوم الزمن. ملمح آخر لرومانسيته يتجلى في رفضه للرطانة الفلسفية، ما أسس عنده لنوع خاص من الكتابة تقوم على قناعته بأن التعبير عن الفكر ينبغي أن يكتسي رداءً أدبياً، وهو ما برز في معظم دراساته سواء في «رسائل عن التربية الجمالية للإنسان» أو «عن الشعر الحساس والشعر الفطري» أو في قصائده الفلسفية أو دراساته الأدبية ومقالاته المختلفة، وكأنه يريدنا أن نكون مثل أبطاله التراجيديين، وكلٌّ منا يقول: «أنا جنتي وأنا جحيمي»، أو رُبَّما يرغب في أن نصل معه إلى الغبطة الروحية في كل ما خطَّت يداه، مُردِّدين نشيده إلى الفرح: «انطفئي يا ملايين الكائنات.. فأنا أمنح العالم أجمع هذه القبلة/.... تألَّموا بشجاعة أيّها الملايين.. عانوا من أجل عالم أفضلَ».
بديع صنيج
06 يونيو . 3 دقائق قراءة

